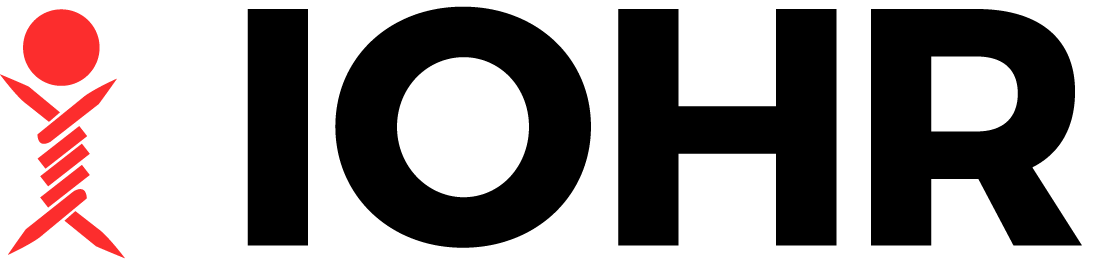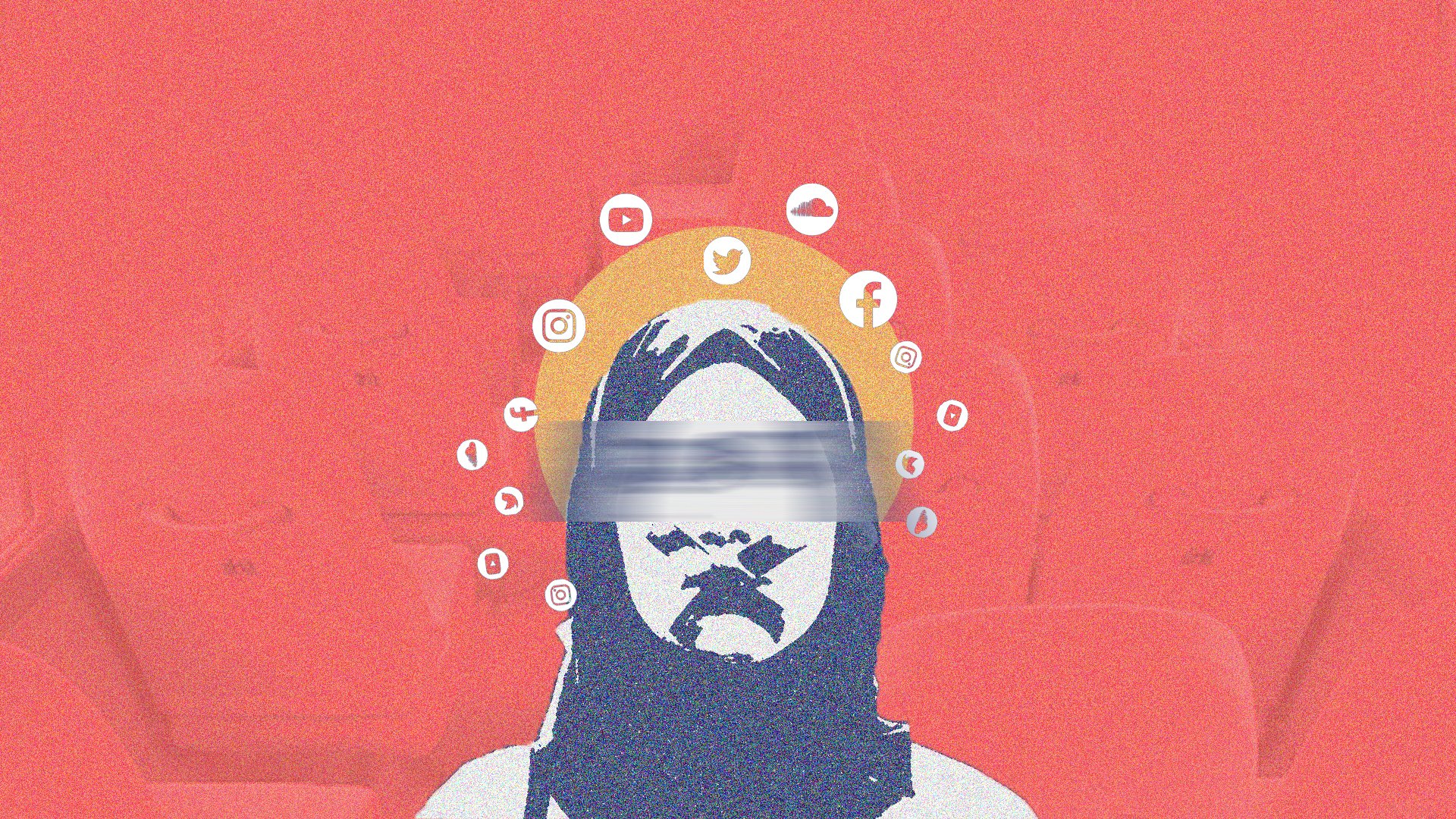نشر في جمار ميديا
في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وثّقت فتاة من بغداد واقعة تحرش تعرّضت لها في إحدى وسائل النقل العام، وشاركتها من خلال صديقاتٍ لها في الفضاء الإلكتروني لفضح المتحرش والمطالبة بالقصاص القانوني منه. سرعان ما شاركت نساء أُخريات الفيديو، وحدثت ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وانتقلت إلى وسائل الإعلام المرئية. ساهم انتشار الفيديو بحدوث جدل كبير، ونجمت عنه ردود أفعال متباينة.
من ناحية، تشجعت نساء من أعمار وخلفيات متعدّدة على الحديث عن تعرّضهن للتحرّش بشكل أو بآخر، وأعلن الكثير منهن تضامنهن مع الفتاة. ومن ناحية أخرى، اعترض البعض على تصوير المتحرش وهو يمارس الاستمناء في وسيلة نقل عامة لأنهم رأوا في ذلك انتهاكاً لـ”حريته الشخصية”. فيما شجب آخرون قيام الفتاة بتصوير المتحرش موجهين لها اتهامات تطعن بأخلاقها وسمعتها، كما صرحت بذلك شخصية إعلامية في برنامج تلفزيوني. وعلق فنان عراقي في خاصية الـ”ستوري” على تطبيق “الانستغرام” باللهجة العامية: “يمعودين ترة موصوج الذيب…إحجولي ليلى شعدها بالغابة بنصاص الليالي.. غير ما نكدر نحجي.. خلونا ساكتين”، في تشبيه واستعارة مقززة، الغرض منها الطعن بأخلاق الضحية وتحميلها الذنب الذي اقترفه المتحرش.
تكررت ردود الفعل بعد أن انتشر فيديو مشابه صورته فتاة أخرى لسائق أجرة يعمل ضمن شركة خاصة تستخدم تطبيقاً الكترونياً على غرار تجربة “أوبر” في دول أخرى، وتستخدمها النساء باعتبارها أكثر أماناً من الوسيلة التقليدية لطلب سيارات الأجرة لكونها توفر المعلومات الشخصية للسائق. ولكن الفيديو الصادم أظهر الفتاة وهي ترتعد خوفاً بينما تصور السائق وهو يمارس الفعل الفاضح ذاته. وعلى الرغم من الشكوى التي قدمتها الفتاة للشركة، إلا أنها لم تلق آذاناً صاغية بل اتُهمت بالتلفيق، كما بينت ذلك على حسابها الشخصي على “تويتر”.
ولم تختلف ردود الأفعال كثيراً حين انتشر فيديو جديد للنائب في دولة القانون، باقر الساعدي، وهو يصور زميلته في البرلمان العراقي من دون علمها. برّر البعض للنائب بأنه لم يتجاوز على زميلته بل إنه كان يصور مجريات الجلسة فقط. وعلى نحوٍ مماثل، ألقى البعض اللوم على فتاتين تعرضتا لتحرش جماعي في مدينة ألعاب قضاء القرنة في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، في ظاهرة مستوردة نسبياً حديثاً من بلدان أخرى، وصل إلى حد تمزيق ملابسهن على مرأى الجميع مما اضطرهن إلى الاختباء في كشكٍ صغير حتى استدعاء القوات الأمنية التي اكتفت بنقلهن إلى مكانٍ آخر دون محاسبة الجناة. وبحسب شهود عيان، فإن إحدى الفتاتين أغمي عليها من دون أن يتدخل أحد لحمايتها، بل حتى من قام بتصوير الواقعة كان يذم الفتاتين بسبب ملابسهن متلفظاً بكلمات نابية. وعلى الرغم من الإدانة الشعبية للفيديو الصادم، لم يتردد البعض في التشكيك بأخلاق الفتاتين لتجرؤهن على دخول مدينة ألعاب في منطقة مُحافِظة تحكمها الأعراف والعادات العشائرية.
وفي الفترة نفسها تقريباً، ظهر فيديو جديد يُظهر تحرش شخصيات إعلامية وسياسية بمقدمة برامج معروفة وعلى الهواء، بدون أن تعترض أو تستنكر. فبادر الكثيرون إلى وصف تعليقات الضيوف على جمال مقدمة البرنامج بأنها لا تتعدى مجرد كونها “تغزّل”.
كيف يستفحل التحرّش؟
تفاقمت ظاهرة التحرش في العراق إلى حدٍ باتت آفة اجتماعية تُضاف إلى قائمة تهديد أمن المجتمع، وتحديداً النساء. تضعنا ردود الأفعال حولها أمام مفارقة غريبة وتساؤل مشروع في آن: كيف يُمكن أن يستفحل التحرش بمختلف أشكاله في مجتمعٍ يدّعي التمسك بالقيم والأخلاق والفضيلة، بل ويميز نفسه عن باقي المجتمعات بصفة “الغِيرة” للدلالة على الحمية والذود بالنفس للدفاع عن الوطن والأهل والنساء؟ وهل من الأخلاق في شيء أن نبرر للمتحرش؟ وهل من الأخلاق في شيء أن نتحرش بالضحية مرتين: مرة من خلال الفعل ذاته ومرة من خلال التبرير للمتحرش والتعاطف معه؟ أم أن الخلل يكمن في هذه المفاهيم، خصوصا مفهوم “الغِيرة”، وكيفية تحويلها إلى سيف ذكوري يُسلّط على رقاب النساء تحت ذريعة “العرض” و”الشرف” و”العفة”؟ فأصبح التحرش بذلك مقبولاً لتوبيخ وعقاب المرأة “المنفلتة” حسب وجهة نظر وتعريف المجتمعات المحافظة، وإقصائها من الوجود والمشاركة في الفضاء العام؟
للإجابة على كل هذه التساؤلات، ولأننا نحتاج إلى إعادة تعريف الكثير من المفاهيم الخاطئة، من الضروري أولاً أن نبدأ بتعريف التحرش نفسه والوقوف عند أسبابه المتعددة والمتداخلة.
يُعد التحرش من أنواع الانتهاكات الجنسية التي تُمارس من دون موافقة الطرف الآخر- وغالباً ما تكون المرأة- في أي مكان وفضاء عام أو خاص، سواءً في الشارع أو مكان العمل أو مكان الدراسة، بل وحتى في المنزل. ويشمل التحرش مجموعة من السلوكيات والتصرفات العنيفة جسدياً ونفسياً التي تمارس عنوة، بخلاف رغبة الآخر وتتجاوز على خصوصيته وتتسبب بإحراجه وإزعاجه وإهانته أو تخويفه أو الإساءة اليه أو استباحته، أو كل ذلك جميعاً.
أشكال التحرش عديدة، منها التحرش اللفظي عن طريق ترديد عبارات غزل وتعليقات على الشكل وطريقة اللبس، عادة ما تكون غير لائقة أو بذيئة أو طلب معلومات شخصية أو القيام بحركات وإيماءات جسدية كالغمز والصفير والصراخ. كما يشمل التحرش الجسدي عن طريق اللمس أو الملاحقة اللصيقة للمرأة، وصولاً إلى التحرش الجنسي الذي يشمل مشاركة صور إباحية والكشف عن أجزاء حساسة في الجسد أمام الضحية وممارسة الاستمناء في الأماكن العامة. ومع التقدم التكنولوجي الهائل المتمثل بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتجددة، يضاف نوعٌ آخر للتحرش يسمى بـ”التحرش الإلكتروني” ومن أشكاله إرسال صور إباحية والتهديد والابتزاز.
تهدف كل أشكال التحرش الى إخضاع وتخويف الضحية، ولكنها تصل أيضاً إلى مدى أكثر وحشية وهمجية، حينما يُقْدم مجموعة من الأشخاص على التحرش الجماعي بالمرأة في الأماكن العامة والاعتداء عليها جسدياً أو جنسياً، بغية إذلال الضحية وسلب كرامتها لأنها لم تكن على هوى الأعراف المجتمعية السائدة.
آفة التحرش منتشرة في كل المجتمعات ولا تنفصل عن جملة مفاهيم وأفكار متغلغلة في المنظومة الأبوية الذكورية، وبموجبها تتوزع وتتحدد الأدوار المجتمعية بشكلٍ هرمي يعطي الأفضلية والأولوية للرجل على حساب المرأة. ويبدأ غرس هذه الأفكار كالنقش على الحجر منذ الطفولة بسبب التربية التي تميز بين الأولاد والبنات حسب الجنس البيولوجي.
وفي العراق، أسوة بمجتمعات محافظة أخرى، ينال الولد الذكر استحقاقاً لفرض السيطرة والتحكم على البنات في محيطه، مقابل حرية عقلية وجسدية غير مقيدة نسبياً في الحركة والخيارات والقرارات الشخصية. وعلى النقيض من ذلك، تنشأ الفتاة على فكرة الخضوع للسلطة الذكورية مع تحميلها مسؤولية حماية نفسها بالستر والنأي بالنفس عن الوقوع في “العيب والخطيئة والحرام”، وإلا فستواجه عواقب وخيمة.
وهنا نكون أمام مفارقة أخرى: على الرغم من التربية التمييزية والهرمية، هناك اعتراف غير مباشر بدور الرجال في إلحاق الأذى بالمرأة. لكن بدل أن ينشأ الرجل على مبادئ وقيم أخلاقية تمنعه من التعدي على النساء، يُطلب من المرأة أن تتأهب وتحْذر من الرجال وهي وحدها من يتحمل تبعات أي انتهاك أو إساءة قد تتعرض لها.
تساهم هذه التربية في خلق الظروف المناسبة والممكنة للتحرش، والتي تغذيها سرديات دينية وثقافية طاغية، رسّخت لهذه العلاقة الهرمية والنظرة الدونية للمرأة. هُمِّش وفقاً لهذا مبدأ “غض البصر”، الذي يأمر الرجال بغض بصرهم عن “الفواحش” إن صح التعبير، فلو التزم الرجل بغض بصره لما اتخذ التحرش وسيلةَ ضبط لـ”غير الملتزمات” بالعرف الاجتماعي، مقابل مبدأ “النهي عن المنكر”المرتبط غالباً بالمرأة وإصلاحه يتم عن طريق الرجل صاحب السلطة شبه المطلقة.
نتيجة لذلك، نجد أن أكثر الفئات عرضة للتحرش هي الفئات المستضعفة في المجتمع، خاصة النساء والأطفال. فالسلطة تعني امتلاك الفضاء العام والسيطرة عليه، وحين تكون المرأة جزءاً من هذا الفضاء، تتحول من ملكية خاصة للأب أو الأخ أو الزوج أو العشيرة، إلى ملكية عامة، فيصبح التحرش سلوكاً مشروعاً.
أعراف وعشائر تبيح التحرش
استحواذ السلطة (الذكورية) على الفضاء العام الذي تتحول فيه المرأة إلى ملكية عامة، يحدّ من قوة الردع لهذا التملك والعنف والتحرش الذي يبيحهما. ويُعدّ غياب الإحصاءات الرسمية حول التحرش، مؤشراً على افتقار السلطة إلى الرغبة والإرادة في تشخيص العنف والتحرش كآفة اجتماعية يتوجب التصدي لها، كما هو حاصل في العراق.
إلى ذلك يُضاف غياب قوانين رادعة تعرّف التحرش صراحة وبشكل مباشر على أنه جريمة، ما يعزز ظاهرة التحرش وتناميها. وتكمن أهمية القوانين الرادعة بكونها تشكل حائط الصد الأول في تحجيم التحرش والتخفيف من آثاره الجسدية والنفسية والعاطفية على الضحية. فنجد أن قانون العقوبات العراقي لا يحوي أي نص قانوني يستخدم مفردة التحرش. عوضاً عنه تُستخدم مفردات أخرى للدلالة عليه، كمفردات اعتداء “بالقوة” أو “التهديد” أو “بالحيلة”، كما تنص المادة 396. وبموجبه يُعاقب المدان بالسجن سبع سنوات وتشدد العقوبة إلى عشر سنوات في حالات معينة، مثل كون المجني عليه/عليها دون الـ18عاماً. أو من خلال عبارة “من طلب أموراً مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان أو أنثى” أو “من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه خدش حياءها”، كما نصت المادة 402 من القانون ذاته، وتكون العقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة، على أن تضاعف إلى ستة شهر وغرامة في حال تكرار نوع الجريمة نفسه خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.
وحتى في حال وصلت القضايا للقضاء بناء على هذه المواد القانونية، فتطبيق القوانين والأحكام غالباً ما يكون محدوداً أو حتى معدوماً بسبب تدخل العشائر ولجوئها إلى الصلح العشائري، كما يشير تقرير يوثق شهادات عن حالات التحرش نشره مؤخراً “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”. ثمة إنكار ورفض شديدين للاعتراف بالتحرش، خاصة من قبل المنظومة العشائرية التي تحاول الطمطمة عليه، لأن الاعتراف بالتحرش سيتنافى مع ادعاءاتها القائمة على فكرة المجتمع المحافظ على النساء. فالقبول بأن يتم التحرش بواحدة من أفراد العائلة أو العشيرة، سيعني التسليم بحقيقة فشل النظام القبلي في الحفاظ على المرأة وحمايتها عن طريق التضييق عليها وممارسة الوصاية على جسدها والتحكم بحركتها.
ويدل رضوخ المحاكم العراقية للسلطة العشائرية على ضعفها وهشاشة المنظومة القانونية والتشريعية في العراق ومؤسسات الدولة عامة، والتي تآكلت بعد أن نخرها الفساد والمحاصصة والمحسوبية وتفتيت وإضعاف المنظومة الأمنية الرسمية مقابل سيطرة الميلشيات والفصائل المسلحة. ويفتح هذا الضعف المجال أمام تقوية النفوذ والسلطة العشائرية والدينية. فوفقاً لشهادات عددٍ من النساء تحدثت إليهن الباحثة بلسم مصطفى فأن القوات الأمنية تتقاعس في التدخل لحمايتهن إذا ما قررن اللجوء إليها لردع المتحرشين.
التحرش.. حتى على شاشات التلفاز
لا يفوتنا أن نعرج على الدور السلبي الذي تلعبه السينما العالمية والعربية والإعلام والأعمال الدرامية والأغاني العربية في تجميل التحرش وتطبيعه، عن طريق تناوله بإطار كوميدي ساخر يجعل المشاهد يضحك مع المتحرش على الضحية، ويحوّل التحرش إلى ممارسة مقبولة جداً وإهانة النساء إلى مثار للضحك، بحيث يصعب بعدها النظر إلى التحرش على أنه انتهاك جسدي أو جنسي، بل يصبح رديفاً للطافة والبسمة وحس الفكاهة في ظل غياب النقد البناء لعقودٍ من الزمن.
فمن يستطيع بالنهاية المساس بفنانين محبوبين مُنحوا ألقاباً أحاطتهم بهالة من القدسية؟ ما غيّب النقد لأعمالهم والاعتراف بأنها ساهمت بجعل التحرش أمراً عادياً ومستساغاً. فمن يستطيع المساس بـ”الزعيم” عادل إمام أو “نجم الجيل، أسطورة القرن” تامر حسني مثلاً، وهما يمارسان التحرش بشكلٍ مباشر أو ضمني في العشرات من أعمالهم الفنية لتمر مرور الكرام ويتقبلها الجمهور والنقاد على أنها مجرد كوميديا. ولذا، حتى لو أدان الإعلام العربي ظاهرة التحرش فإنه يغض النظر عن دور فنانين من الوزن الثقيل في استفحاله.
أما الإعلام العراقي فليس بأفضل حالاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، برنامج “ولاية بطيخ” الشهير يحاول معالجة الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع من خلال الكوميديا، إلا أنه دأب في طريقة تناولها على الانتقاص من المرأة وتكريس الصور النمطية ذاتها حول الرجل والمرأة في العراق. والتحرش هو أحد الأدوات التي استخدمها البرنامج لتمرير تلك الصور. فعلى مدى المواسم الماضية، أستُخدم التحرش كمادةٍ للتندر والفكاهة وقُدِّم على أنه شيء اعتيادي ومقبول، لا بل محبب وخفيف الدم أيضاً.
في أحد المشاهد التي عُرضت في الموسم السادس قبل عامين، نرى أربعة شبان في الشارع وهم يندبون حظهم ويبكون لأنهم مسالمين وغير عنيفين ولا يعرفون التعامل مع المجتمع من حولهم، فيقررون أنهم سيتغيرون من خلال ممارسة “التصجيم” -وهي المفردة العراقية العامية المرادفة للتحرش اللفظي-، ف”التصجيم” على حدّ قول أحدهم سيجعلهم “أدبسزية” (أي غير مؤدبين). فتمر في هذه الأثناء امرأة شابة من أمامهم تبادر إلى التحدث إليهم للسؤال عن بيت إحدى معارفها التي تسكن الحي، فينتهز الشبان الفرصة للتحرش بها ولكنهم يخفقون في ذلك أمام سخرية الشابة التي تلقنهم درساً في النهاية في كيفية ممارسة التحرش على أصوله.
إن هذا المشهد القصير هو مثال صارخ على تماهي “ولاية بطيخ” مع السرديات المجتمعية والثقافية الطاغية حول معاني الرجولة. فالرجل المهذب والخلوق مرفوض مجتمعياً، وحتى يصبح رجلاً بحق يكون التحرش الوسيلة المناسبة لتحريره من التهذيب ولصقل رجولته. التحرش يُعتبر فعلاً بطولياً يتفاخر عادةً الرجل بممارسته لأنه دليل على رجولته.. حتى أن المرأة العراقية نفسها تسخر منه سخريةً لاذعة من خلال رفضها لشخصية الرجل المؤدب، فما كان منها إلا أن تُعلّمه التحرش الصحيح! وهنا أوصل البرنامج رسالة خطرة أخرى عن رضا وسعادة المرأة العراقية حين تتعرض للتحرش.
وبرنامج “ولاية بطيخ” ليس الوحيد بهذا الصدد، فبرنامج كوميدي آخر باسم “خوش حچي” اوصل الرسالة نفسها في أحد مشاهده بين الشخصيتين الرئيستين في حلقاته: المرأة سعيدة وهي ترى الرجل يتحرش بها على طريقة الستينيات أو السبعينيات من القرن الماضي. تكمن الخطورة في مثل هذا المشاهد في تصوير التحرش اللفظي على أنه غزل وليس انتهاكاً لخصوصية المرأة.
وفي برنامج حواري آخر، سُئلت ممثلة عراقية عن رأيها في العقوبة المناسبة للمتحرش فأجابت:”أن يتم التحرش به”، فرد عليها المحاور: “والله افرح إذا تحرشتِ بيّه”.
ومع تفاقم حالات التحرش ورفض النساء العراقيات المتزايد له، التفت صُناع برنامج “ولاية بطيخ” أخيراً للأمر، إذ حاول البرنامج معالجة هذه الظاهرة في إحدى حلقات موسمه الجديد من خلال تسليط الضوء عليها في الدوائر الحكومية بإطار كوميدي لا يخلو من السطحية والإشكالات. فهل من الممكن نقد هذه الظاهرة من خلال الكوميديا والضحك؟ وسنضحك على أو مع المتحرش في هذه الحالة؟ وحتى مع المعالجة الكوميدية الإشكالية، عزز السيناريو للمفاهيم الإشكالية المنتقِصة من المرأة نفسها وربطها بـ”العرض” أو “شرف الزوج” في حالة المشهد المذكور.
محجبة أو غير محجبة.. دائماً مُلامة!
تكاد جميع الإناث، من الفتيات والنساء، بمن فيهن كاتبات هذه السطور، أن تكنَّ تعرضن إلى التحرش وقررن عدم البوح، والتزام التكتم خوفاً من “اللوم” و”التشكيك” و”غياب التعاطف” معهن.
فلماذا تُلام الضحية؟ في ضوء كل ما سبق، سيبدو الجواب بديهياً: إلقاء اللوم على المرأة وتحميلها مسؤولية الانتهاكات التي تتعرض لها هي ثقافة متجذرة في جميع المجتمعات، إذ تُغذيها جملة من الصور النمطية والخرافات والأعراف المجتمعية الخاطئة، وتُستخدم فيها الأديان تحديداً كأداة لترسيخ هذه الثقافة وبالتالي في خلق أنظمة اجتماعية مستندة عليها.
نرى ذلك مثلاً من خلال الخطاب الديني والفقهي الذي تفرضه السلطات الدينية الإسلامية، ومن ضمنها تلك التي في العراق، والذي تميزه القراءات الذكورية الإقصائية للمرأة أو المقلِّلة من حجمها وشأنها في الحياة والمجتمع. كما تذكرنا الأكاديمية المغربية النسوية الراحلة فاطمة المرنيسي والباحثة اللبنانية ريتا فرج، أن هذا الفقه قد أسس لخطاب مناهض للمساواة بين الرجل والمرأة من جهة، وتمييزياً بين المرأة المحجبة وغير المحجبة، من جهة أخرى.
فأصبح بذلك التعاطف مع المرأة مشروطاً بمدى “عفتها” و”شرفها” و”حيائها” بحسب المعايير الدينية والعشائرية كذلك، والتي غالباً ما ترتبط بطول ثوب المرأة ومقدار ما تغطيه من جسدها والتزامها حدود المنزل قدر المستطاع، تجنباً للاختلاط بالرجال.
وببحثٍ سريع على موقع اليوتيوب، سنجد العشرات من الفيديوهات المكرسة لهذا الخطاب التمييزي والاقصائي، منتصرة بذلك للمتحرش حتى ولو تمّ ادعاء العكس. فالمفارقة أنه إذا تمت إدانة التحرش فإنها تقترن بتذكير المرأة بأنها المتسبِّبة بشكل مباشر أو ضمني عنه، وهذا شجب يطرح إشكالية لوم الضحية نفسها، ويفقد تأثيره بمجرد الحديث عن ملابس المرأة أو طريقة كلامها أو سلوكها وغيره، كأسباب ودوافع للتحرش.
وتجدر الإشارة إلى أن الادعاء القائل بـ”حصانة” المرأة المحجبة ضد التحرش، سواء اللفظي أو الجسدي، وكل أشكال الانتهاكات الأخرى غير صحيح. فلو نظرنا إلى مصر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يعتبر الحجاب دارجاً بشكل كبير، فإن الأغلبية العظمى من النساء تصل إلى نسبة 99 في المئة كنّ قد تعرضن للتحرش، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة عام 2013.
وإن كانت ثقافة لوم الضحية ظاهرة عامة في جميع البلدان، فإنها تختلف في حدتها من سياق لآخر وبحسب العوامل والقوى التي تجتمع وتتفق على لوم الضحية، إما بسبب ملابسها أو شكلها أو طريقة كلامها أو ضحكتها أو حركاتها أو تحركاتها، كما تستعرض الباحثة جيسيكا تايلور في كتابها “لماذا تُلام المرأة على كل شي: كشف النقاب عن ثقافة لوم الضحية”. وبحسب تايلور، فإن لوم الضحية يمحو الجاني من الصورة ويبرئه من المسؤولية ولا يسمح بمحاسبته.
وفي العراق، فإن الدولة والعشيرة والمجتمع يُساهمون بقصد أو بدونه بمحو الجناة من الصورة، مما يترتب عليه إلغاء مسؤوليتهم اتجاه الضحايا. أولاً، بعدم اعتبارها ضحية وإنما مسؤولة عما حصل معها، وبالتالي إهمال التعامل مع الآثار النفسية والجسدية التي تعاني منها. وثانياً، بتثبيت وترويج سردية لوم الضحية وعدم العمل على توعية الجناة والمجتمع عامة على نبذ هذه السرديات والممارسات التي تنجم عنها.
هاتفكِ سلاحكِ.. توثيق التحرش مقاومة، وإذا ما كانت السلطات، بجميع أشكالها، لم تتحرّك للوقوف بوجه ظاهرة التحرّش، فإن النساء الضحايا قررن التصدي للتحرش بأنفسهن وكسر حاجز الصمت، ولو بشكل جزئي، من خلال اللجوء لكاميرا الهاتف النقال والسوشيال ميديا كسلاح لردع المتحرشين.
لم يكن الفيديو الذي صورته الفتاة في وسيلة نقل عامة في منطقة الكرادة الأول من نوعه. فعلى مدى السنوات الأخيرة، وبين فترة وأخرى، تتم مشاركة تجربة مريرة لضحية من ضحايا التحرش أو حتى فيديو أو صور توثق للحادثة عن طريق الضحية نفسها، أو بمساعدة ناشطات، أو صفحات خاصة بمجموعات، أو منظمات تُعنى بحقوق المرأة.
وانضمت نساء كثر إلى هذا التصدي عبر مشاركة تجاربهن، حيث وجدن في التفاعل الكبير مع الفيديو وانتشاره فرصة سانحة لهن لكسر الأغلال المجتمعية والتحدث عن تجارب قاسية بغية تحقيق العدالة، ولو جزئياً، فما لبث أن انتشر وسم #اوقفوا_متحرش_الكرادة من أجل لفت نظر الرأي العام والمؤسسات الحكومية المعنية، مما شجع أُخريات على حذو خطى الفتاة الشجاعة ونشر فيديوهات أخرى تباعاً، مع تكرار دعوات كانت قد انطلقت خلال العام الماضي بفضح أو تصوير المتحرش كنوع من الردع أو العقوبة المجتمعية، لتحل محل العقوبة القانونية شبه الغائبة بهذا الصدد.
وهذا الحراك المحلي ليس استثنائياً، فهناك حراكات إقليمية مشابهة ضد التحرش الجنسي، كما يحصل في حراك مصر المناهض للتحرش وحملة “لن أسكت” في الكويت مثلاً، والتي وصفها الإعلام على إنها نسخٌ محلية للحراك العالمي “أنا أيضاً” (#MeToo) وفي حالة العراق تحديداً، فإن كسر حاجز الصمت حول التحرش واللجوء إلى الهاتف النقال كسلاح رادع للتوثيق والفضح بالاستعانة بمواقع السوشيل ميديا، هو حراك محلي بقيادة شابات عاديات لسن شخصيات مشهورة على غرار حراك “أنا أيضاً”، وهو منبثق من رحم معاناة وواقع المرأة العراقية، خصوصاً في حقبة ما بعد 2003.
هيمنت في هذه الحقبة الأعراف والمنظومة العشائرية وحلّت مكان المنظومة القانونية والقضائية، مصحوبةً بضعف المنظومة الأمنية لصالح الميليشيات والفصائل المسلحة، ما خلق بيئة خصبة للتحرش وكافة أنواع الانتهاكات الأخرى. كما أن التواصل السريع مع العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل سلبي من قبل البعض، ساهم أيضاً في التعرف على سبل وأشكال جديدة من التحرش.
الحراك ضد التحرش باللجوء الى الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، ما هو إلا حركة مقاومة تقودها ضحايا التحرش رغبة في إحقاق العدالة عن طريق العقوبة المجتمعية، في ظل غياب رديفها القانوني، طامحات بذلك إلى جعل المتحرشين يرتدعون مستقبلاً عن اقتراف أفعال مماثلة خوفاً من التشهير والفضيحة إما بنشر صورهم أو حتى معلومات شخصية عنهم.
وبالفعل فبعد انتشار وسم #اوقفوا_متحرش_الكرادة، وفي أعقاب الضجة والجدل الكبير الذي أحدثه الفيديو وتضامن الكثيرين مع الفتاة، خصوصاً من النساء، وردت أخبار عن إلقاء القبض على المتحرش بعد كشف هويته. من هنا، فلم يكن مستغرباً أن تسمع كاتبة المقال، “بان ليلى”، حينما كانت تمشي في إحدى شوارع بغداد بعد فيديو التحرش، رجلين يتمازحان ويوصيان أحدهما الآخر بأن يلتزموا حدود الأدب كي لا يتم تصويرهم وفضحهم في الفضاء الالكتروني.
تضامن المجتمع مع المرأة
المقاومة بالتوثيق والنشر هو فعل شجاع، ولكنها محفوفة بالمخاطر لغياب السند والدعم العائلي، لذلك فالكثيرات لا يقمن بتبليغ أي أحد ولا سيما عائلاتهن حينما يتعرّضن للتحرش.
وفي بيئة تحكمها العشيرة والفصائل المسلحة ورجال الدين، تظل أسئلة تتعلق بسلامة الفتيات اللاتي يقررن اتخاذ هذه الخطوة والعواقب التي ربما ستواجههن إذا ما انكشفت هوياتهن. ولا يمكن التنبؤ برد فعل المتحرش في كل مرة في بلدٍ تسيطر عليه الميليشيات والسلاح المنفلت. وربما ذلك يفسر ارتجاف فتاة في مقطع مصور لاحق لفيديو متحرش الكرادة وهي تصور المتحرش (سائق سيارة الأجرة في حالتها) خوفاً من عواقب التصوير.
وهذه المخاطر تطرح سؤالاً حول دور المجتمع المدني في إسناد النساء في معركتهن ضد التحرش، إذ أن هذا الحراك وحده ليس كافياً من دون وجود تضامن حقيقي بين النساء والمنظمات النسوية المعنية. فعلى الرغم من تسليط الأخيرة الضوء على حملة #صوري_المتحرش و#إفضحي_المتحرش ودعمها لها، ما يزال هناك الكثير للقيام به.
ووفقاً لناشطات عمل بعضهن في هذا المجال، فإنه حتى مع وجود الكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والإنسان، إلا أن تأثير معظمها يظل محدوداً ومقتصراً على فئة معينة. تتسم أغلب البرامج التي تتبناها هذه المنظمات بالرتابة والتقليدية والافتقار إلى رسم استراتيجيات فاعلة للوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع، مما تسبب بخلق فجوة كبيرة بينها وبين المرأة العراقية وهمومها.
وتُعلّق الناشطة النسوية زهراء وليد بهذا الصدد: “إن هناك عراقاً غير العراق الذي نعمل به (في المنظمات)، عراق بعيد عن عمل منظمات حقوق الإنسان والنشاطات النسوية وحملات التوعية والندوات والورش التي تتحدث عن العنف والتحرش. فما حدث في البصرة هو حالة اعتداء جماعي، وأشعر أننا بمعزل عما يحدث، ونعمل بشكل بعيد ولدينا الكثير من المشكلات ونقاط الخلل وفجوات كبيرة بين العمل والواقع، وإلا فليس من المعقول أن ألف شاب واقف ولم يقرأ منشوراً عن التحرش أو تأثر بالأفكار التي نعمل عليها منذ سنين وليس لديه اي نسبة وعي تجعله يقف بوجه هذا الاعتداء الوحشي”.
تحتاج المرأة العراقية إلى وقفة حقيقية معها في مواجهة آفة التحرش، والدعوة إلى مجابهتها عن طريق تشريعات تحميها وتنصفها حتى تستطيع إكمال مسيرتها في الحياة وفي الدراسة وفي العمل. تحتاج إلى تكاتف المؤسسات القانونية والإعلامية والتعليمية لوضع خطط وسياسات تعالج هذه السلوكيات من الجذور، تحتاج الى إعادة التفكر في منظومتنا الأخلاقية وصياغة مفاهيم جديدة تُمكّن من محاسبة الجناة وتزرع الثقة في المرأة العراقية نفسها. فالمنظومة القائمة فشلت فشلاً ذريعاً في حفظ كرامتها وحمايتها واستقلاليتها وفي تحقيق الأمن المجتمعي عموماً.
المرأة لا تحتاج إلى كليشيهات تذكرها بأنها الأم والأخت والزوجة والحبيبة بينما هي مهددة ومستباحة ومنتهكة في كل مكان. هي تحتاج أن تعرف أن ما تتعرض له من انتهاكات ليس ذنبها وليس خطأها. بل ذنب وخطأ الجناة. ووحدهم من يستحق العقاب. تحتاج أن تسترد أبسط حقوقها في الحياة: العيش بأمان.